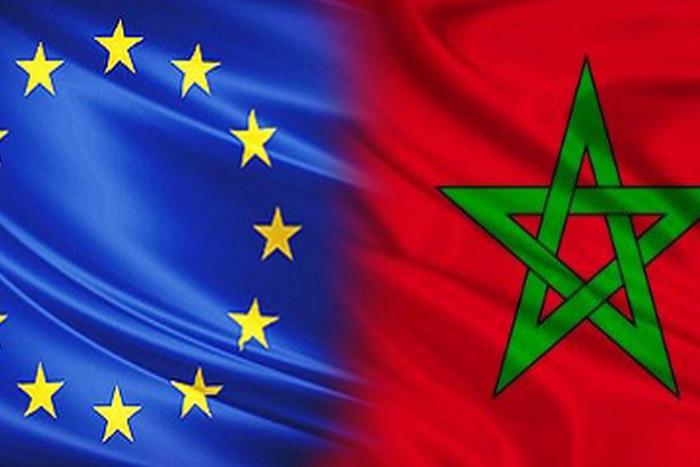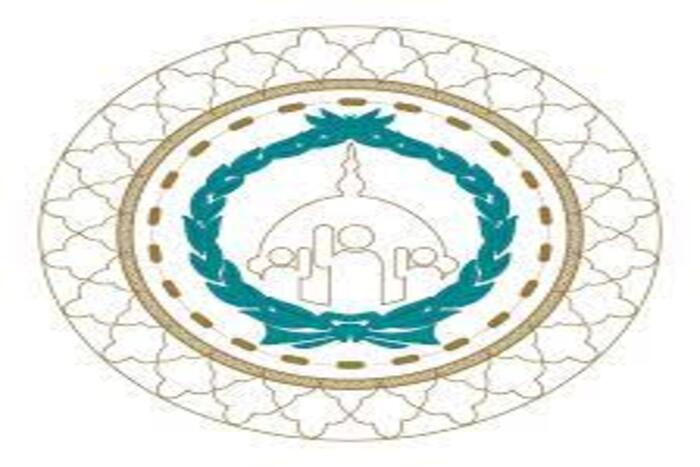سؤال الثقة إلى أين ؟

نولد ونحن نمتلك مشاعر قوية بخصوص الثقة، على اعتبار أن الثقة جزء لا يتجزأ من هويتنا وكينونتنا كبشر، يسعى إلى التعاون ونسج أواصر المحبة والمشاعر الرقيقة، وهذه الألفة المتأصلة في الإنسان تكبر ويكبر معها الشعور والميل نحو المحبة من خلال بناء الثقة مع الآخرين.
غير أنه كلما تقدم الإنسان في السن، إلا وتراجع غالبا منسوب الثقة لديه في كل شيء، خاصة عندما يكتوي المرء بنيران الإفراط في توزيع بطائق الثقة مجانا، فيتسلل إليه اليأس ويتعمق لديه الإحباط، وهذا أمر يؤثر سلبا على السلامة الصحية والنفسية للفرد، فتتراكم التجارب السيئة المفضية إلى عدم الثقة كرد فعل للحفاظ على الذات من الاختراق، وإن كان هذا الاختيار لا يجعلك إنسانا موضوعيا، بسبب الإفراط في الخوف والارتياب.
ولذلك يساعد الحوار البناء ووضوح الرؤية على بناء الثقة، بينما يؤدي التكتم والخداع إلى انهيارها، خاصة عندما لا تكون التفاصيل واضحة، فإننا غالبا ما نوظف خبراتنا وغريزتنا لتدلنا على الأشخاص الممكن الوثوق بهم، هذا الإحساس بدوره لا يخلو من مخاطر، لكونه محدودا نسبيا أثناء قراءة الإشارات، نظرا لبراعة البعض في قدرته على تزييف هذه الرموز، وامتلاكه ما يكفي من أدوات الخداع.
وهذا ينطبق عموما على ما نعيشه اليوم من أزمة تعليمية حادة، يجعل المرء يتساءل عن موقع الثقة بين الفاعل السياسي وعموم موظفي القطاع في تدبير الملفات المطلبية، ولذلك فسؤال الثقة أصبح طافحا، يتخذ بعدا آنيا واستراتيجيا في نفس الوقت، نظرا للحالة الراهنة التي نعيشها جميعا، وما تشهده منظومة التربية والتكوين من أزمات واحتقان منذ 5 أكتوبر2023، الذي يصادف اليوم العالمي للمدرس، جراء الطريقة المتسرعة التي مر بها مرسوم النظام الأساسي رقم .2.23.819 الخاص بموظفي قطاع التربية والتكوين عبر القنوات الدستورية، مما يطرح أكثر من علامات استفهام.
وهو النظام الذي قيل عنه قرابة سنتين عادلا ومنصفا ومحفزا، هذه الانتظارية التي دامت أكثر من عقد من الزمن، لا شك أنها رفعت من سقف المطالب، خاصة مع تراكم الملفات وغلاء الأسعار، ونفاذ مخزون الصبر، كلها عوامل خلفت أزمة حادة لدى جميع فئات القطاع، إن لم تكن أزمة اجتماعية يقودها قطاع التربية والتكوين بالوكالة، فلأول مرة كانت الاحتجاجات منظمة ومنسقة بعناية، حظيت بدعم كامل من الأسر والمثقفين والمهتمين والإعلامين، وأجمع الكل على مظلومية المحتجين، وعلى ضرورة إنصافهم إنصافا كاملا، بما يعيد للمدرسة العمومية قيمتها ومكانتها المجتمعية، بعدما تعمقت أزمة الثقة بين الأساتذة والوزارة الوصية والحكومة ككل.
وفي هذ السياق، يطرح سؤال مركزي، لماذا الفاعل السياسي غالبا ما يراكم وينتج الأزمة عوض حلها؟ والواقع أن الجواب على هذا السؤال المتشعب والمتداخل، يتخذ بعدا تاريخيا منذ استقلال المغرب، وما عاشه من صراعات قوية حول السلطة، لعب فيها التعليم قطب الرحى في صناعة الوعي من قبل النخب، ولذلك كل الإصلاحات - رغم ما حققته من إيجابيات - كانت بهدف فرملة الوعي المجتمعي، من خلال تراجع المدرسة العمومية بكل مكوناتها، وإن كان لهذا التوجه من باب الموضوعية ما يبرره خلال حقب معينة، أما وقد توضحت الأمور وانكشفت النوايا، ولم يعد هم المواطن إلا تحقيق الكرامة والعيش بحرية، مع الإيمان بالثوابت الوطنية، ظهر ذلك جليا مع تفاعلات كوفيد 19، وما حققه المنتخب المغربي في تظاهرة كأس العالم بقطر، وزلزال الحوز...، أظهر تعبئة مجتمعية قل نظيرها، مما يؤشر على التمسك بالهوية الوطنية المغربية الصادقة وراء صاحب الجلالة، عوامل كلها انتفت معها المبررات والمخاوف المبالغ فيها، وظهر الفاعل السياسي عاجزا عن مواكبة وقراءة تحولات الواقع الجديد بعمق وموضوعية، سعيا إلى تعزيز الاستقرار وفتح أبواب الأمل نحو الالتحاق بالدول النامية، من خلال الاستعداد للتظاهرات الدولية، والجاذبية القوية التي أصبح المغرب يتمتع بها قاريا ودوليا، وكأننا نسير بسرعتين متناقضتين، قد تعرقل كل منهما الأخرى، هذا التفاوت في الانفتاح، عمق الهوة بين المواطن والفاعل السياسي الذي أصبح همه الرهان على المقاعد الانتخابية، وتخلى عن مهام التأطير وإنتاج النخب والمثقفين، مما قوى حظوظ التكنوقراطية، وإن كان مشهود لها بالكفاءة التقنية، إلا أنه ينقصها الوازع السياسي في تنزيل الخطط والمشاريع التنموية، بسبب ضعف المناورة وانسداد الأفق المفضي إلى الانفراج والأمل، وهي خاصية تتميز بها هذه الحكومة عموما، فتضطر إلى نهج سياسة الغموض واللف والدوران، إلى جانب ضعفها في التواصل المقنع والفعال، كلها عوامل تقوض منسوب الثقة، باعتبارها ورشا أصبح الاشتغال عليه أولوية ملحة، ليس إلا.